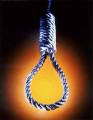يوميّات مقدسيّ
بقلم:- أسامة عباس
طالما امتكلتني رغبةٌ عميقةٌ لتدوين مذكرات ملئت بها حياتي في مدينة القدس قلب الصراع.. تمتد بين مواقف غريبة في حافلات تقع تحت تهديد عملية استشهادية، تقل مسافرين يهود يمتلكهم رعبٌ عميقُ من موتٍ مفاجأ.. أو حوادث خطيرة مع جنودٍ اغبياء زرعوا في كل زاويةٍ أو زقاقٍ من أزقة القدس العتيقة.. امتلكتني رغبةٌ جامحة في استفزاز غبائهم وجهلهم المطقع لاستثارة خوفهم الوجودي وأزمتهم الأخلاقية. فهذا مسافر يهودي يرتاب من ملامحي العربية ويعتقد أنّي استشهاديٌّ فأشفق عليه من خوفه فأحاول طمأنته على حياته..
وذلك جنديّ يطلب مني كشف حقيبتي سائلاً: ماذا تخبأ في حقيبتك؟ فأرد عليه مستفزاً صريحاً معه: معي سلاح!.. فيحمر وجهه خائفاً من هول الصدمة. ولكني حفاظاً على سلامتي اخرج له مسرعاً من حقيبتي، كتاباً عربياً أذكر أنّه للمفكر الفلطسيني الراحل إدوارد سعيد.. قائلاً له بنبرة استعلائية واثقة: هذا هو سلاحي!.. ولكنه لم يكتفي وأصر على دفعي لاستفزازه قائلاً: "حسبتك جندياً فلسطينياً، لكنت كسرت لك عظامك".. فرددت عليه قاصداً ابعاد خطره المزيف عني ضارباً ثقته الرسمية في نفسه: أنا متأكد أنك إذا واجهت جنديّاً فلسطينياً بظروف متكافئة ومواجهة برية بدون دبابتك وطائرتك فلا شك عندي أنّه سيهشم لك وجهك، ويدوس على صورتك المزيفة في قلوب منهزِمين وأبناء قومك المحصنين.
ولكنَّ هذه المواقف وآخرى كثيرة.. لم تكن من القوة والهيمنة كي تدفعني لتدوينها.. حتى كان يوم الجمعة الأخير.. بعد أن امتطيت سيارتي عائداً من طريق الخليل ماراً في شارع رقم (1) قرب باب العمود متوجهاً لشقتي الواقعة في التلة الفرنسية. هذا الشارع الذي يفصل شرقي القدس عن غربها(1).. ومعروف أنّ هذا الطريق كان الخط الذي يفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات الأردنية حتى عام 1967.. إلى أن احتلت إسرائيل باقي مدينة القدس والضفة الغربية خلال حرب الأيام الستة في ذات العام. فعلى شرقي هذا الطريق تقع غالبية الأحياء العربية مثل وادي الجوز والبلدة القديمة والطور ورأس العمود وغيرها.. ومن غربيه الأحياء والتجمعات اليهودية.
عندما اقتربت في سيارتي من باب العمود استوقفتني الإشارة الضوئية الحمراء.. وإذا بشاب يهودي يسألني: هل وجهتك التلة الفرنسية؟ فرددت عليه ب:نعم. مدركاً أنّه يهوديٌّ دون أن يمتلئ نظري بملامحه وملابسه.. ودون أن أستفيض في التفكير ومحاولة اتخاذ القرار. فاستدار الشاب متحركاً نحو الباب ليفتحه ويجلس بجانبي، ولكنه تفاجأ لملامحي العربية ولصوت الراديو الذي يصدع بالعربية.. فكرر عليّ السؤال نفسه قاصداً ومحاولاً التهرب من الموقف والخروج من السيارة ولتدارك الأمر! ولكني أكدت عليه وبشدة وكأنّي في هذه اللحظة توصلت لقناعة مطلقة بعد تفكير عميق وقرار صائب : نعم.. نعم إنّي متوجهٌ إلى التلة الفرنسية.. فاصعد هيا!!.. وبدأتُ مسرعاً بتحريك السيارة حتى لا تتسنى له الفرصة للخروج منها!.
بدأت بعدها في اكتشاف ملامحه اليهودية.. وتأملت وجهه الذي يقطر منه تطرفاً أعمى .. وملابسه التي تشير إلى انتمائه العقائدي ليهود متعصبين يجمعوا في عقيدتهم الدين والقومية: أصحاب الطقية (قبة) المُحيّكة (כפה סרוגה). فهذا الشاب المُقبب يلبس البنطال الأخضر لباس الجيش الإسرائيلي الذي لا يغيب عن ذهن أيّ طفل فلسطيني من الضفة أو غزة أو الداخل الفلسطيني. بنطال تتدلى منه الخيوط من جانبيّه معبرة عن تديّنه المفرط. وهؤلاء هم أشد اليهود تطرفاً وعداءاً للعرب والفلسطينين. فهم القوميون المتدينون الذين يدافعوا ويتمسكوا بمبدأ الاستيطان في أرض إسرائيل.. والذي يتشكل منهم الجيش الإسرائيلي في غالبيته من ضباط برتبهم المتعددة وجنود مقاتلين بوحداتهم الخاصة والمتعددة. وهذا الشاب الجندي ومن على شاكلته ينتمون لمدرسة الحاخام كوك الروحية والفكرية.. ونعلم انّ شاباً فلسطينياً من حيّ جبل المكبر في شرقي القدس اقتحم مدرستهم في غربي القدس العام الماضي ليقتل منهم ويجرح الكثير.
بعد أن استحضرت هذه الخلفيات المركبة لهذا الجنديّ بدأ صراعٌ داخليٌّ ممتزجاً بمتعة حقيقية طالما انتظرتها. صراع يمتد بين فلسطينيتي التي تتحمل الآن جنديّاً صهيونيّاً بما تحمل هذه التسمية من معانٍ عنصريّة همجيّة .. لا تتردد في إلقاءه عبر سيّارة تسير سرعة الضوء لتخفيه عن الوجود... إلى مقدسيّتي التي تختزل الصراع التاريخي بين الطرفين لتحوله لصراع بين شخصين داخل السيّارة ساقه قدر الله في لحظة عابرة.. إلى قضيّتي الفلسطينية التي تحرق وجداني إذا لم أختطف هذا الجنديّ.. لربما كان على أرض غزة قبل أيام قليلة!!! فقتّل وشرد وانتهك. وأمّا المتعة التي تخفف عنيّ احتراق وجداني على قلة حيلتي.. فتلك الرجفة التي رأيتها واستشعرتها في كيان هذا الجنديّ.. حتى جعلته كالخرقة لا حول له ولا قوة ينتظر مصيره بعد خطأ استراتيجيّ ارتكبه حين فكر في صعوده للسيّارة.
قد استمتعت حين علم أنّ مُعينه في التوصيلة فلسطينيّ.. وحين حاول التهرب بنفسيّة المهزوم ليخرج نفسه من السيّارة.. وحين استفاض في سماع صوت الأغاني العربية من إذاعة رام الله .. ولو كنت وحدي في السيّارة لبدلتها بصوت من القرآن الكريم على شريط لا أملك غيره يرتل فيه سورة إبراهيم.. تلك السورة التي يقول الله فيها: "ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله".
مهما أوتيت من قوة العبارة-وأنا ضعيف في ذلك أصلاً- لما استطعت وصف تلك النفسية والحالة الوجدانية التي سيطرت على هذا الجنديّ. وفي اللحظات الأولى لصعوده تحيّرت هل أفتح معه جدلاً وطنياً في قلب الصراع- الأمر الذي أجيده ببراعة بالذات مع اليهود المتطرف- أمّ أستمتع في كل لحظة بهذا الشعور اللذيذ فلا أفسده في كلام لعله يكسر الصمت المخيف ويشعره ولو نسبياً بالآمان والسكينة. ولكنّي تمنيّت رغم كرهي الشديد لأزمات السيّر أن تشتد أكثر من ذلك.. فلا تنطويَ المسافة وتمتد لحظات المتعة أكثرَ فأكثر. متعة تقلب عنده عذاباً وكأنّه تحت وطئة ضربات جلاد أحد السجون المظلمة.. ينتظر مصيراً حتميّاً بالفناء. وعلى هذا الطريق الذي يشطر القدس شطرين.. ثوانٍ قليلة -إن أردت ذلك- وإذ بالسيّارة في إحدى أحياء القدس العربية.. وأعلن عن اختطافي للجنديّ ثم نبدأ بالتفاوض على صفقة أسرى.. لعلها كانت فرصة بغض النظر عن نتائجها عليّ! والسؤال هل تنجح العملية أم تفشل؟.
وكان جندي يدرك أن هذه الطريق تقف بين عالمين بالنسبة له.. الأول يشكل بيتاً آمناً بالنسبة له.. والآخر لا يمثل بالنسبة له إلا الموت والخوف والعداء اتجاهه.. وقد بدى خوفه من كوني فلسطينياً يمكنّي بثوان قليلة الاختفاء بسيارتي يميناً نحو أزقة القدس المجهوله والمخيفة له. ولعله شعر لثوانٍ قليلة في هذه اللحظات منذ صعوده للسيّارة بالشعور بالآمان.. عندما سبقتني سيارة شرطة عسكرية إسرائيلية فتقدمتني حتى المفرق القادم. ولكن ما فتأ أن تبدد هذا الاطمئنان حين وصلتني مهاتفة من أخ لي من قيادة الحركة الإسلامية.. فشكرته على المكالمة التي قدرها الله حتى أزيد من ارتباك الجنديّ بكلامي العربي.. ولكن كان ذلك تقريباً في اقتراب نهاية الرحلة قريباً من التلة الفرنسية.. فاعتذرت للأخ على قطع المكالمة كي أتوجه للجنديّ بسؤال قررت منذ اللحظات الأولى للموقف أن أسأله إياه: מתי חזרת מעזה?! بنبرة استحقار له .. فرد عليّ بعد أن اطئن لوصوله للمحطة: לא הייתי, חבל!! فقلت له مستنكراً: למה חבל!! فرد عليّ بكل صراحة لا تعبر إلا عن تربيته العنصرية الهمجية: חבל, שלא הרגתי ערבים. فقلت له ببرودة الآيس من إنسانيته: אתה נהנה להרוג ערבים?. قال بعد اطمئنانه على سلامته: כן. כמה שיותר להרוג ערבים.. זה טוב(1).
خرج الجنديّ سالماً.. تركني والتفكير بعنصريته المتأصلة .. وكيف أنّها مهيمنة على الضمير اليهودي ودولة الحل الصهيوني.. الذي يبرر بكل طريقة ووسيلة تقتيله لأطفال ونساء وشيوخ بالمئات في حربها على غزة.. الفرق أنّ هذا اليهوديّ قالها بكل وقاحة وصراحة لا يخاف أن نقدمه لمحكمة الجنائية الدولية.. ولكن دولته تتوارى عن هذه الصراحة محاولة تحسين صورتها.. ولكنها لا تختلف أخلاقيّا وجنائياً عن هذا الجنديّ الذي يتشكل الجيش بغالبيته على شاكلته.
لم أندم على "توصيلته".. فقد استمتعت من شعوره العميق بالخوف.. ولعل أنّه أشفى غليلي للحظات. وهذا موقف يبرهن أنّ اليهودي حتى في دولته لن يشعر بالأمن والآمان .. ولكنّي كفلسطيني رغم الاحتلال أشعر بالأمن والسكينة.. في حيفا وفي يافا وفي قلب المشروع الصهيوني أيّنما كان!! وهذا اختلاف عميق بين وجودي الفلسطيني ووجوده الصهيوني. فبعيداً عن ترسانتهم العسكرية التي تخبأ وراءها خوفٌ عميقٌ متجذرٌ، أدركت أنّ خسائر إسرائيل البشرية في حربها الأخيرة على غزة..لا تقاس بعدد الجنود الذين سقطوا على أرض غزة.. بل بعدد الجنود العائدين لخوفهم بعد المعركة.
وصدق الشاعر:
أعداؤنا خوفهم لهم مدد, لو لم يخافوا الأقوام لانقطعو
فخوفهم دينهم وديدنهم عليه من قبل يولدوا طبعوا
قل للعدا بعد كل معركة جنودكم بالسلاح ما صنعوا
لقد عرفنا الغزاة قبلكم, ونشهد الله فيكم البدع
ستون عاماً وما بكم خجلٌ, الموت فينا وفيكم الفزعُ.
=====================
القدس 6\2\2009
(1) أفضل بل أنا أدعو المسلمين لاستعمال عبارة: شرقي القدس وغربي القدس.. وليس العبارة التي تسوق لنا: القدس الشرقية أو القدس الغربية. فاستعمال الثانية كأننا نتفق على أن القدس قدسان شرقية وغربية.. وهذا خطأ. بل القدس واحدة لها شرق ولها غرب كما لها شمال وجنوب. كما نقول شرقي يافا وغربي يافا، كأنّ يافا يافتان. إنما "القدس الشرقية" يستعملها من يرضى بتقسيم القدس وحلول التسوية أو التصقية.
(2) لمن يحتاج قاموساً بالعبرية.. الترجمة بالترتيب: متى عودت من غزة؟ \ لم أتواجد هناك.. خسارة \ لما خسارة؟! \ خسارة أني لم أقتل عرباً \ أنت تتلذذ بقتل العرب؟! \ نعم..كلما قُتل عربٌ أكثر .. أفضل.